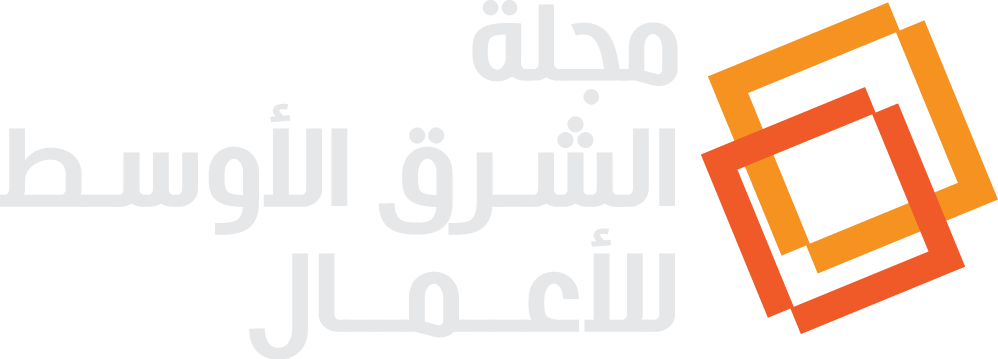كيف نقرأ الإفرازات الاقتصادية والاجتماعية للحرب على غزة في أسبوعه الرابع
بينما يتواصل ويتصاعد العدوان الحربي الإسرائيلي ضد قطاع غزة وأهله الصامدون، مستهدفاً بذلك الشعب الفلسطيني أينما وجد، وأمام المآسي الإنسانية الكبرى المتراكمة في غزة والخسائر البشرية المهولة التي لا تتوقف عن التراكم يوما بعد يوم، قد تبدو الأبعاد الاقتصادية لهذه الأحداث شأناً ثانوياً والتفكير بها ترفاً. مع إتمام الحرب أسبوعها الرابع دون أي وضوح حول مداها الزمني ونتائجها العسكرية والجيو-سياسية المحتملة، تصبح كذلك محاولة حصر تكلفتها، أو قيمة الخسائر المحتملة، عملية مشكوكا بجدواها اليوم، بل بملائمتها كونها افتراضية وأكاديمية في وقت لا يزال الأطفال يسقطون والدماء تسيل.
بالتالي من الممكن في هذه المرحلة المبكرة فقط تحديد وحصر أبرز الآثار المتوقعة على الاقتصاد الفلسطيني جراء الحرب وتبعاتها، وطبيعة الصدمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الجارية والقادمة، التي لا بد من التهيؤ لمواجهتها والاستجابة لأثارها. ذلك ناهيك عن النقاش حول إعمار غزة وجعلها آهلة في أعقاب هذه الكارثة، الذي بدوره أيضاً مبكرٌ التفكير به، خاصة في خضم ما يروج له إسرائيلياً وأميركياً حول ترتيبات “حوكمة” القطاع فيما يسمى بـ “اليوم التالي”. سيحدد مسار ذلك الموضوع الشائك والمصيري نتائج الحرب الميدانية ومدى تحقيق أو إفشال أهداف إسرائيل المعلنة في تدمير/إزالة/إنهاء حكم حماس في قطاع غزة، وهي نتائج لا يمكن التكهن بها أصلاً.
لتسهيل مهمة التمسك بمختلف التأثيرات الحاصلة والمتوقعة، بات من الضروري فصل التشخيص الخاص بقطاع غزة عن ذلك الخاص باقتصاد الضفة الغربية ومناطق فلسطينية مجاورة (القدس المحتلة والداخل المحتل العام 1948)، حيث أنها ستُخضع جميع هذه المناطق التي يقطن فيها 7 ملايين فلسطيني إلى عدد من الصدمات المشابهة والسياسات الاقتصادية المعادية والعنصرية الإسرائيلية، مع الفارق الكبير بين ما يحصل في قطاع غزة وفي بقية مناطق فلسطين.
- اقتصاد قطاع غزة: من المنكوب إلى المدمر
بينما كان يوصف قطاع غزة بعد 15 سنة من الانقسام والحصار بأنه على حافة الانهيار، يستنتج من حجم التدمير والقتل والتهجير حتى تاريخه، أن اقتصاد غزة توقف عن العمل اعتباراً من الربع الأخير لعام 2023 ولأجل غير معروف. إذا كان هناك نشاط “اقتصادي” في غزة اليوم، فهو لا يتعدى كونه اقتصاد كفاف، أو اقتصاد البقاء على قيد الحياة.
مع تدمير البنية التحتية الاقتصادية والسكنية المتواصل لأسابيع إن لم يكن لأشهر، يصبح الحديث عن “خسائر” في الجانب الاقتصادي، كما في جولات سابقة، غير واقعي وغير مجدٍ وغير مفيدٍ. أمام مشهد حرب بين قوتين، إحداهما عملاق عسكري يحركه اقتصاد بحجم 150 ضعف الطرف الفلسطيني المنهك أصلاً، فإن هدف إعادة اقتصاد قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل 2023 ليس كافٍ، ومفهوم “التعافي” الاقتصادي لا ينطبق هنا. أصلاً، لن يكون من الممكن إعادة تحريك عجلة الاقتصاد السلعي والخدمي والمالي بعد هذه الحرب، إلا بعد تلبية الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة وغير المحسوبة، لإطعام وإيواء ورعاية أكثر من مليوني فلسطيني مشرد ونازح وجريح ومصدوم في قطاع غزة المنكوب والمتردي بشكل كبير منذ العام 2007.
من جهة ثانية، توفر بعض المؤشرات التاريخية صورة أولية عن الجانبين الأساسيين لما ستخلفه هذه الحرب في أعقابها، وهما في خسارة قيمة الناتج المحلي الإجمالي وثم في الدمار المادي للمساكن والمنشآت الاقتصادية والخدمية والخاصة والعامة. من الواضح أن الجولات السابقة للحروب على غزة (خاصة 2009 و2014) كانت أقل شراسة ولم تشمل جميع مناطق القطاع. ولم تنطوي عليها أزمات إنسانية ونزوح سكاني بحجم ما شهدناه وسنشهده، ولم تخلق خلالها حالة جوع وعطش ومرض وصدمة نفسية وغيرها من الإفرازات الإنسانية لهذه الحرب، التي ما زلنا نتلمس أشكال جديدة لها يومياً. شكلت صدمة الحرب في جولات سابقة نكسة للاقتصاد الغزي على شكل تراجع لم يتعدى الـ10% العام 2014، سرعان ما تم التعافي منها بإطلاق إعادة الإعمار خلال السنة التالية. منذ ذلك الوقت، لم يسجل اقتصاد القطاع نمواً يعيده لما كان عليه قبل الانقسام والحصار، حين كان ما زال يشكل ثلث “الاقتصاد الوطني الفلسطيني”، بينما وصلت حصته إلى حوالي 17% عشية الحرب، بإنتاج محلي لم يصل 3 مليارات دولار.
هكذا يقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الإنتاج المحلي الإجمالي الغزي لربع واحد بحوالي 700 مليون دولار، ما ينذر بضربة قاسية بخسارة ما لا يقل عن %25 من الناتج المحلي (الضئيل) في 2023، وربما مثيله في الربع الأول من 2024 الذي قد لا يشهد استئناف النشاط الاقتصادي العادي حتى ولو أُسكتت المدافع. المهم هنا ليس فقط حجم الصدمة المحتملة للإنتاج الاقتصادي فحسب، بل للقدرة على إعادة تدوير العجلة الاقتصادية و”التعافي” من صدمة توصل الاقتصاد إلى نقطة الصفر لـ3 أشهر أو أكثر. هذه مهمة قد تستغرق سنة أو سنوات قبل عودة اقتصاد القطاع لمستوى إنتاج ما قبل الحرب. بالتالي ستكون هناك حاجة لمدة 3-6 أشهر لإغاثة 2.2 مليون غزي وإعالتهم إلى أن يكون من الممكن العودة للعمل المنتج.
ما يجعل تحدي إعادة تشغيل الاقتصاد بعد هذه الحرب مختلفاً تماماً عن التجارب السابقة، هو حجم الدمار المادي الذي يزداد يومياً في المساكن والمصانع والمنشآت التجارية والمرافق الخدمية التعليمية والصحية والمعيشية، دون إمكانية حصرها حتى الآن. لكن المؤشرات المتوفرة تظهر حتى الأسبوع الرابع من الحرب صورة لتدمير واسع النطاق في القطاع وبشكل مكثف في مربعات كاملة لمدينة غزة، ما خلّف مساحات مسطحة من الردم. حتى تاريخه يقدر أنه تم تدمير ما يزيد على 44 ألف مسكن تدميراً كاملاً وما يزيد على 132 ألف وحدة سكنية تدميراً جزئياً، ما يمثل قرابة الـ 50% من “مخزون مساكن” القطاع، بالإضافة إلى 150 مصنعاً و120 مدرسةً والعديد من المباني العامة. بالتالي ما يواجهنا هو تعطيل لكامل البنية التحتية الاقتصادية في شمال القطاع حتى الآن، وإرباك ما تبقى من الاقتصاد وبنيته في جنوب القطاع.
لأغراض المقارنة مع صدمات سابقة تعرض لها الاقتصاد الغزي، يشير البنك الدولي مثلاً إلى أن العام 2014 شهد اجتزاء 460 مليون دولار من اقتصاد غزة (تراجع في الناتج المحلي). يشير الأونكتاد إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن حرب 2008 بلغت 2.5 مليار دولار، وأن الأصول التي تضررت من حربي 2012 و2014 بلغت 2.7 مليار دولار، وأن السلطة الفلسطينية قدرت إعادة الإعمار بـ 3.9 مليار دولار. إذاً، من الآن نستطيع تقدير الحجم الخيالي المحتمل لتكلفة الحرب على غزة في جانبي الإنتاج والبنية التحتية.
- الضفة الغربية: إدارة اقتصاد مجزئ ومحاصر
مقابل مشهد التدمير الاقتصادي المتعاظم في قطاع غزة، فإن الاقتصاد في الضفة الغربية لم يتصدع بعد، رغم العديد من الإجراءات الإسرائيلية الأمنية التقييدية والاعتداءات المتصاعدة للمستوطنين في مختلف المناطق. بينما يشارك الفلسطينيون في مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية الهم الوطني الأوسع من خلال مظاهرات متواصلة وتضامن شعبي واسع مع المقاومة ومع أهل غزة، ويشاركون في أعمال مقاومة مسلحة وشعبية راح ضحيتها حتى الآن 110 شهيد، إلا أن الاقتصاد الخاص بقي يعمل ولو بوتيرة منخفضة، وما زالت الخدمات الحكومية والبلدية تعمل ويحاول العمال الوصول الى أماكن عملهم. يعمل كذلك القطاع التجاري على تسيير تدفق السلع والخدمات ودورة الأعمال قدر الإمكان. الوضع ليس طبيعياً، لكنه ليس أيضاً متأزماً، طالما يسود حد أدنى من الاستقرار الداخلي تضمنه أجهزة الأمن الفلسطينية، بينما يتصدى أهالي القرى بأنفسهم لاعتداءات المستوطنين خارج مناطق نفوذ السلطة.
لكن، وحتى دون اشتعال “لجبهة شرقية” يؤدي إلى مواجهات عسكرية واسعة في الضفة الغربية، بدأت القنوات المتوقعة تظهر انتقال الآثار الاقتصادية لحالة الحرب الفلسطينية-الإسرائيلية إلى اقتصاد الضفة الغربية، ما ينذر كما في حال قطاع غزة، بأن الأمور الاقتصادية الفلسطينية لن تعود إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر.
هناك عدد من مكامن الضغط المتزايد على نسيج اقتصاد الضفة الغربية الخاضع لنفوذ السلطة الفلسطينية، بعضها قد تكون صادمة ووشيكة، وأخرى قد تكون آثارها أقل انتكاساً وتأخذ وقتاً أطول للظهور. في جميع الأحوال فإن التجارب السابقة لاستيعاب الصدمات الاقتصادية في الضفة الغربية انطوت على خسائر مادية جراء الاجتياح الإسرائيلي خلال 2001- 2004 وتراجع اقتصادي قارب الـ20% خلال تلك السنوات الأربع، ودمار في المباني والمنشآت العامة وصلت قيمته إلى حوالي 2.5 مليار دولار. أما في العام 2020 انتكس الاقتصاد الفلسطيني جراء جائحة كوفيد-19 بما لا يقل عن 12% خلال سنة واحدة. لم يكن متوقعاً التعافي منه سوى في العام 2023 في حال تحقق نمو بـ 3%، وهو توقع تبخر مع غبار حرب غزة. بالتالي، ما سيواجه الضفة الغربية من أزمات اقتصادية ستأتي عبر عدة موجات متلاحقة، قد تصل لدرجة تسونامي إذا التقت معاً وعززت بعضها البعض، نسردها هنا بحسب مدى عجالتها وتوقع ظهور أصدائها.
أولى هذه الموجات التي ظهرت حتى الآن قد تشكل أكبر صدمة لاقتصاد الضفة الغربية والطلب الإجمالي والاستهلاك. منذ اليوم الأول للحرب وخلال شهره الأول، توقف حوالي 160 ألف عامل من الضفة (أو قرابة 20% من قواها العاملة) و20 ألف من قطاع غزة (ممن سمح لهم خلال السنة الأخيرة بالدخول للعمل في إسرائيل)، عن العمل داخل الأسواق الإسرائيلية. كانوا يدخل هؤلاء العمال (المياومين في الأغلب) للاقتصاد الفلسطيني 3 مليار دولار سنوياً، أو ما يقارب 15% من الدخل القومي المتاح، ما أبقى مستويات البطالة في الضفة الغربية دون الـ20%، بينما بقي مستواها في غزة حوالي 45%. هذا يعني أنه دون إيجاد فرص عمل لهؤلاء في المدى القصير سترتفع نسبة البطالة إلى ما يزيد على 30% في الضفة الغربية (وإلى ربما 90% في قطاع غزة) طوال فترة الحرب.
نظراً لما يمكن توقعه من عدم استعداد قطاعات مشغلة إسرائيلية لإعادة توظيف أيدي عاملة من “العدو” (ما عدا ربما بظروف تشبه معسكرات العمل في السجون)، وعدم استعداد العمال أنفسهم لمواجهة مخاطر العمل لدى إسرائيليين، لا يتوقع عودة السواد الأعظم من هؤلاء قبل انتهاء الحرب، بل لأشهر عديدة، وفي حال قطاع غزة، ربما نهائياً. إن التأثيرات المباشرة بالإضافة إلى مضاعفة أعداد العاطلين عن العمل في الضفة، تتضمن تراجعاً فورياً في الطلب العام والقوة الشرائية للأسر الريفية الأفقر، وفي السيولة النقدية في السوق، وكذلك ضغط نحو الأسفل على مستوى الأجور المحلية، وغيرها من الارتدادات اللاحقة سيكون من الصعب استيعابها دون تحرك سريع واستثمارات وإعانات لإيجاد فرص عمل محلية عاجلة في القطاعات الإنتاجية والإنشائية والخدمية.
أما الصدمة الثانية، التي بدأت آثارها تتلمس في الضفة الغربية ستتشكل من الغياب الطويل المتوقع للزوار والمتسوقين من فلسطينيي 1948 ومن القدس الشرقية إلى أسواق شمال الضفة الغربية ومواقعها السياحية (أريحا، نابلس، ورام الله). ينفق هؤلاء ما يقارب 1.5 مليار دولار سنوياً في الضفة الغربية، وفي الفترة الأخيرة استثمرت أعداد كبيرة منهم في الشقق والمنازل في أريحا ومناطق رام الله. ما يعني انسداد هذا المورد الاقتصادي الهام وعنصر آخر من عناصر تراجع الطلب العام والإنفاق الخاص، الذي “يزيت” العجل الإنتاجي والاستهلاكي والاستثماري لاقتصاد خاص بالكاد كان ينمو قبل هذه الكارثة.
تتمثل الضربة الكبرى القادمة التي قد تكون قاسمة للاقتصاد الفلسطيني، في تهديد وزير المالية الإسرائيلي بوقف تسديد أموال المقاصة الضريبية التجارية الشهرية لخزينة السلطة. تعتبر المقاصة شريان حياة الموازنة العامة وأساس تمويل فاتورة الرواتب لحوالي 150 ألف موظف والنفقات التشغيلية للسلطة والبالغة حوالي 300 مليون دولار شهرياً، وعنصر أساسي في تغذية القوة الشرائية للمستهلكين. تساهم هذه الأموال أيضاً في تمكين الأسر المقترضة من تسديد ديونها للمصارف المحلية (البالغة حوالي 7 مليار دولار)، وكذلك في قدرة الحكومة على تسديد ديونها للقطاع المصرفي (البالغة 2 مليار دولار). حتى في حال مواصلة احترام إسرائيل لالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية (ربما تحت ضغط أميركي)، فإن الانخفاض المتوقع في الاستيراد من إسرائيل ومن الخارج مع التراجع الانكماشي التدريجي في الاقتصاد الفلسطيني سيخفض مبلغ المقاصة الشهرية في جميع الأحوال. بمعنى آخر، فإن أي أزمة في الموازنة العامة تتعدى 2-3 أشهر ستولد متاعب كبيرة للحكومة وستبرز نقاط ضعف في نظام مصرفي ما زال يعتبر متيناً بعد أول شهر من الحرب.
الموجة الأخيرة الهامة المتوقعة في سلسلة الصدمات التي تلوح في الأفق لإضعاف قدرة اقتصاد الضفة الغربية على مواصلة العمل بشكل يبقي احتمال “التعافي” مفتوحاً لاحقاً، تكمن في تعطل الأسواق الداخلية وانقطاعها عن بعضها بسبب إجراءات العزل الإسرائيلي وإفلات المستوطنين ليعبثوا كما يشاؤون. ليس واضحاً بعد مدى تأثير تدهور أحوال النقل التجاري وانتقال الموظفين والعمال على حركة الأسواق الداخلية وعلى وصول السلع الاستهلاكية وكذلك مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي. لكن هنا كما في الأبعاد الأخرى المذكورة، لا بد من التحضير لما ستظهره القطاعات التجارية والخدمية (التي تحظى بحصة الأسد من الناتج المحلي ومن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة) من هشاشة خلال الفترة القادمة. ستتضاعف آثار كل صدمة من الصدمات الأخرى المتوقعة، أمام انخفاض القوة الشرائية وتوقف السياحة ونقل العمال بين المحافظات وإلى إسرائيل، وغيرها من وظائف القطاعات الخدمية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفاصل اقتصادية أخرى.
لم يتطرق كل ما سبق لمخاطر أخرى قادمة من الأزمات الاقتصادية التي تواجه إسرائيل نفسها، ابتداءً من الانخفاض الكبير في قيمة الشيكل، ثم تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي وسياسات الشراء الطارئة للسلع الأساسية في الأسواق العالمية التي ستخصص لدعم “اقتصاد الحرب” الإسرائيلية حصراً. بالتالي وحتى لو لم تدخل الضفة الغربية المعركة العسكرية مع إسرائيل، فإننا مقبلون على حرب اقتصادية على أكثر من جبهة ولّدها ويغذيها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قد تُدخل اقتصاد الضفة أيضا في “مربع الاستهداف” التدميري وتعيد مستوى نشاطه خلال أشهر أو أسابيع الى ما يقارب 40-50% من مستوى دخله الاعتيادي.
- القدس المحتلة والداخل الفلسطيني: جزر معزولة في محيط إسرائيلي
أخيراً وليس آخراً، فإن ما يواجه اقتصاد القدس المحتلة وكذلك اقتصاد فلسطينيي الداخل ليس أقل خطورة، حتى ولو استثنينا احتمال دخولهما في مواجهات عسكرية أو غيرها مما يمكن أن يحرض اليمين العنصري على القيام باعتداءات أو أعمال قتل أكثر مما شوهد حتى الآن. بالنسبة للقدس الشرقية التي يعتمد ثلث قوة عملها على وظائف في الأسواق الإسرائيلية باتت مهددة أو من الصعب الاحتفاظ بها. نسبة مماثلة تعتاش من الحركة السياحية الدولية والفلسطينية المتوقفة تماماً، بما في ذلك القوافل الأسبوعية من فلسطينيي 1948 الذين يزورون المدينة أسبوعياً للصلاة والتسوق. هذه الاتجاهات تعني زيادة عدد العاطلين عن العمل والمعتمدين اعتماداً معيشياً على ما يوفره التأمين الاجتماعي الإسرائيلي من مساعدات شهرية بسيطة وخدمات صحية وبلدية محدودة. بالإضافة، يعيش فلسطينيو القدس الـ350 ألف في حالة عزلة وانقطاع شبه تام عن الوظائف والأقارب والخدمات في الضفة الغربية، تحت رحمة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المجهزة لقمع أي تحرك شعبي أو تعبير وطني، وفي مواجهة حوالي 650 ألف إسرائيلي يعيشون في مدينة القدس، منهم ما يقارب 250 ألف في مستوطنات القدس الشرقية.
أما الأفق الاقتصادي لما يقارب 1.8 مليون عربي فلسطيني في الداخل الإسرائيلي، الذين تنظر لهم الدولة على أنهم “طابور خامس” محتمل، قد لا يكون أفضل بكثير مقارنة بالقدس أو الضفة. يواجه المواطن العربي الإسرائيلي نفس المعاملة العنصرية في مكان العمل التي يتعرض لها عمال الضفة والقدس. بالإضافة إلى التسوق اليهودي المعتاد في الكثير من هذه البلدات الذي بدء في الانكماش أو توقف، يعتمد ما لا يقل عن 40% من العاملين على وظائف خارج البلدات العربية وفي مؤسسات إسرائيلية. قد تنتهي خدمة هؤلاء أثناء فترة الحرب المحتدمة، حتى في غياب بدائل إسرائيلية لملء تلك الوظائف، وبالتالي تصبح العودة إلى الوضع السابق مسألة أشهر وربما سنوات. إذاً هذا القطاع من الشعب الفلسطيني ليس لديه سوى نفسه ودولة إسرائيل لإغاثته ولتلبية احتياجاته المعيشية الأساسية، وأصبح منقطعاً عن المناطق الفلسطينية التي تزايدت التعاملات الاقتصادية معها بشكل ملحوظ في السنوات الماضية.
إذاً، لا يلوح في الأفق أي بريق نجدة أو مسار للتعافي المستقبلي لهذا المكون الهام من الشعب العربي الفلسطيني، سوى الصمت السياسي والصمود المجتمعي والبشري، لعله لا يواجه نفس النكبة التي تحاك ضد بقية الشعب الفلسطيني، في هذه اللحظة التاريخية والمصيرية في النضال المشروع للتحرر من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني وتقرير مصيره الوطني في وطنه.
- خلاصة: من سيدفع فاتورة الحرب الاقتصادية؟
في التجارب السابقة للتعامل مع الصدمات الخارجية، لعبت المساعدات الدولية الإنسانية، ثم مساهمتها في إعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد، دوراً قيادياً في تحمل التبعات المالية للتدمير الإسرائيلي وقيود الاحتلال على النشاط الاقتصادي. يختلف الوضع السياسي والعالمي اليوم اختلافاً جوهرياً، حيث كانت قد انخفضت المعونة الدولية إلى حوالي نصف مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولم تعد تعتمد عليها السلطة سوى لتمويل جزء من موازنتها التطويرية وتحويلاتها الاجتماعية المنخفضة أصلاً. بالإضافة لذلك، فإن الاصطفاف الأميركي والأوروبي خلف إسرائيل في هذه الحرب سيواجه فلسطينياً بالمقاطعة الشعبية، وربما الرسمية. في كل الأحوال فإن أي دور لتلك الأطراف في إعمار غزة سيرتبط بأهداف سياسية مشتركة مع إسرائيل فيما يتعلق بمستقبل الحكم في قطاع غزة.
بالتالي يبقى مشكوكا بنوايا هؤلاء والاشتراطات المحتملة لدورهم. هذا التحدي الكبير في “تعويض” ما تم تدميره وفي “إحياء” شعب منكوب، يبقى مجهول الحجم لكنه قد يصل إلى 10-20 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة. هنا نختتم ونتساءل: إذا كانت الدول العربية عاجزة عن الدفاع عن الشعب الفلسطيني الأعزل في هذه اللحظة، فهل سينهض بأسلوب مغاير عن حلفائه في الغرب ويتحمل التبعات المالية لهذه الكارثة الإنسانية والاقتصادية دون شرط أو قيد؟ ثم، هل يمكن تلمس دور جديد في الساحة الفلسطينية أو الإقليمية ليتحول أصدقاء الشعب الفلسطيني بين دول الجنوب اللاتينية والآسيوية والإسلامية إلى حلفاء في معركة الحفاظ على القضية وتحقيق الحقوق والحياة المسلوبة؟
| مجموعة من المؤشرات لعام 2022 بالمقارنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل | الضفة الغربية وقطاع غزة (مرة) | الضفة الغربية وإسرائيل (مرة) |
قطاع غزة وإسرائيل (مرة) |
| مستوى الناتج المحلي الإجمالي (الأسعار الثابتة) | 5 | 32 | 149 |
| مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (الأسعار الثابت) | 4 | 41 | 146 |
| مستوى متوسط الأجر اليومي لجميع الأنشطة الاقتصادية | 2 | 2 | 5 |
| مستوى البطالة للأفراد المشاركين في القوى العاملة من الفئة العمرية (29-25) | 3 | 6 | 17 |
| حجم الواردات | 8 | 12 | 91 |
| حجم الصادرات | 110 | 137 | 15048 |
| الفقر* | 4 | 28 | 106 |